الثبات على المبدأ.. متى تتأكد من هويتك وتثبت لنفسك أنك على الحق؟
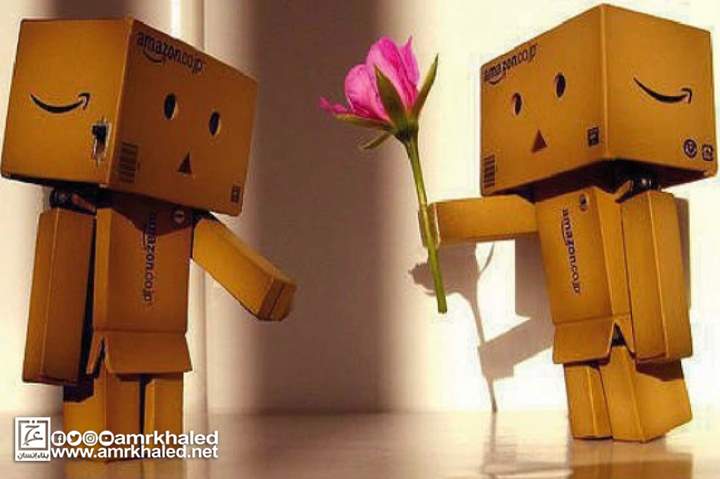
بقلم |
أنس محمد |
الاثنين 15 ديسمبر 2025 - 10:00 ص
يعد التمسك بالحق والثبات على المبدأ من أصعب أنواع الجهاد الإنساني، حيث يميل الإنسان دائمًا إلى تحصيل السلطة والمال، والمنفعة الشخصية، لذلك تجده يدور مع مصلحته حيث دارت، دون النظر لما أعلنه من مواقف سابقة، فسرعان ما ينسى الإنسان مبادئه وأقواله، عند أول اختبار حقيقي له، قد يدفع فيه الثمن من مصلحته الشخصية، وبالرغم من أن الإسلام نبه على حفظ الأرواح والعمل على كل ما ينفع الإنسان ويخدمه، إلا أن الإسلام فرق بين النفاق والمصلحة الشخصية التي تقوم على أكتاف الغير، وبين المصلحة العامة والخير للناس كافة.
كما نبه القرآن على هذا في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) ﴾سورة الصف.
فالله سبحانه وتعالى لا يرضى النفاق لعباده، وهي أن يكون كلامك في واد وعملك في واد آخر، هذا التناقض بين الأقوال والأفعال، هذا الكلام الذي يلقى للاستهلاك والواقع على خلافه، هذا الموقف الازدواجي، والصورة ذات الوجهين المتناقضين.
الثبات حتى الممات
فخلال حياتنا الدنيا نجد كل يوم مئات التصريحات التي تخرج من عشرات المنظرين والخبراء وتتحدث عن المشكلات والحلول، والعيوب، حتى تشعر أن هذا المتحدث عنده الحل ويمتلك العصا السحرية لحل جميع مشاكلنا.
إلا إنه سرعان ما تجد حظ هذا التعيس يوقعه في شر أعماله ويمسك منصبا رفيعا تفاجأ خلال رحلته في هذا المنصب أن ما كان يقوله بالأمس مجرد ترهات لا تسمن و تغني من جوع، وأن ماكان يقوله بالأمس ليس إلا حيلة لتحقيق المصلحة الشخصية.
فكم من مدافع عن حقوق الإنسان وعمل ضدها، وكم من إنسان تحدث عن الأخلاق وافتضح أمره، وكم من مرشح طالب بحقوق الفقراء وكان اول من أكل أموال اليتامى.
لذلك إن أرفعَ مراتب الثبات وأعلى درجاته ثباتُ القلب على الحق، واستقامته على الدين، وسلامته من التقلب.
ولذا كانت الخشية من الزيغ، شأنَ أولي الألباب ونهجَ أولي النهى وسبيل الراسخين في العلم، الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويزدلفون إليه، يرجون رحمته ويخافون عذابه.
وقد ذكر سبحانه تضرّعَهم وسؤالهم إياه التثبيتَ على الحق والسلامةَ من الزيغ في قوله عز اسمه: (هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَـابَ مِنْهُ آيَـاتٌ مُّحْكَمَـاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَأُخَرُ مُتَشَـابِهَـاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَلراسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ كُلٌّ مّنْ عِندِ رَبّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَـابِ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ) [آل عمران:7، 8].
اقرأ أيضا:
الجائز والممنوع في الاختلاط بين الرجال والنساء في المناسباتتمام القدوة
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك" ، قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال: "نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله، يقلّبها كيف يشاء" أخرجه الترمذي.
وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله برسالة الإسلام الخالدة إلى الثّقلين، وقفت منه قريش موقفاً معانداً؛ فكفرت برسالته، وكذبته -وهو الصّادق الأمين- واتَّهمته بما هو منه براء -إذ اتَّهمته بالكذب مرّة وبالسّحر مرة وبالجنون مرّة وبالكهانة مرّة- وحاولت صدّه بكُلّ السُّبل؛ فصبّت عليه فى أول الأمر غضبها، وأذاقته كلّ ألوان العذاب، لعلّها تصرفه عن الدّين الجديد الذى جاء به، كما قاطعتْه وحاصرتْه، فلمّا لم يَفُتّ ذلك فى عضد النّبى صلّى الله عليه وسلم ذهبوا إلى أبى طالب عمّ النّبى؛ فقالوا له: يا أبا طالب إنّ لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا، وقد طلبنا منك أنْ تنهى ابنَ أخيك فلَمْ تَنْهه عنا، وإنّا والله لا نصبرُ على هذا، حتى تَكُفّه عنا، أو نُنَازله وإياك فى ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين، وانصرفوا .
فعظم على أبى طالب فراقُ قومه، وعداوتهم له، ولم يَطِب نفساً بإسلام رسول الله لهم ولا بخذلانه، فبعث إليه، فقال له: يا ابن أخى، إنّ قومك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا...، فأبقِ على وعلى نفسك، ولا تُحمّلنّى من الأمر ما لا أَطيق.
فظنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلم أنّه قد بدا لعَمّه فيه ما لم يظهر من قبل، وأنّه خاذله مُسْلمه، وأنّه قد ضَعُف عن نصرته والقيام معه. فقال النّبى كلمته التى تستحق أن تُكْتب بماء الذّهب والتى سجّلها التّاريخ وخلّدها: «يا عم، والله لو وضعوا الشّمسَ فى يمينى، والقمرَ فى يسارى، على أن أتركَ هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أَهْلك دونه ما تركتُه».
ثم بكى وقام، فناداه عمّه أبوطالب فقال: أقبلْ يا بن أخى، فأقبلَ الرّسول عليه. فقال له: اذهب فقُلْ ما أحببتَ، فو الله لا أخذلك ولا أُسلمك لشىء أبداً.








